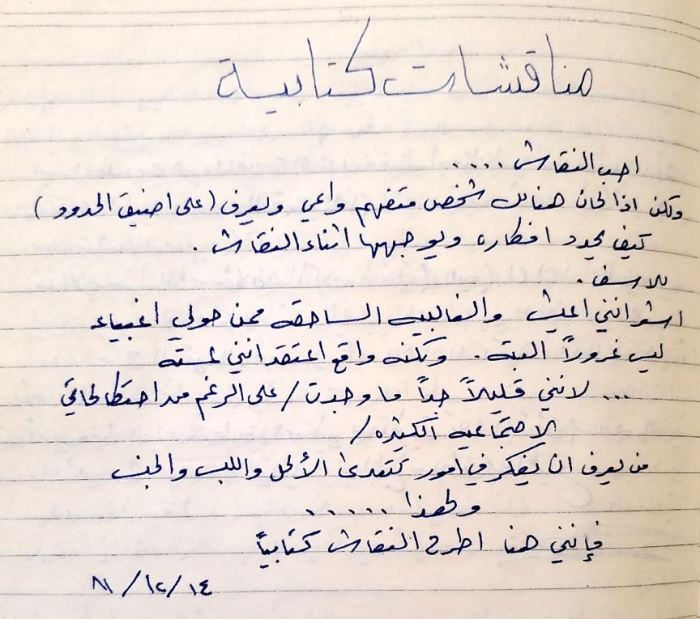يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
يصادف منتصف الشهر القادم ذكرى وفاة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين السادس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي توفى عام 64 هجري المصادف ل 12 تشرين الثاني عام 683 ميلادي أي قبل 1336 عام
ولد يزيد قرب مدينة الضمير الحالية لأم عربية مسيحية هي ميسون بنت بحدل بنت زعيم قبيلة كلب
:توفي في حوارين جنوب شرق حمص ودفن في مقبرة باب الصغير في دمشق التي قال فيها المعري
غيرُ مجدٍ في ملّتي واعتقادي نوح باكٍ ولا ترنم شاد
وشبيهٌ صوت النعيّ إذا قِيس بصوت البشير في كل ناد
أبَكَت تلكم الحمامة أم غنّت على فرع غصنها الميّاد
صاح هذي قبورنا تملأ الرُحبَ فأين القبور من عهد عاد
خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
في عام 49 هجري الموافق 674 ميلادي وخلال خلافة والده معاوية بن أبي سفيان قاد يزيد الجيش والأسطول الإسلامي في حصار القسطنطينية الذي استمر أربعة سنوات ولكنه فشل في إسقاط المدينة التي استشهد على أسوارها أبو أيوب الأنصاري
توفي معاوية عام 60 هجري بعد أن اختار ابنه يزيد خليفة للمسلمين جاعلا الخلافة وراثية بعدما كانت شورى أو غلبة
حكم يزيد لفترة 3 سنوات ونيف حصلت خلالها الفتنة الثانية حيث ثار الحسين بن علي ثم استشهد في معركة كربلاء وثار أهل المدينة المنورة فأرسل يزيد جيشه لسحق معارضة أهل المدينة المنورة وانتصر عليهم في معركة الحرة ونهب جيشه بيوت أهل المدينة المنورة فثار عليه عبد الله بن الزبير الذي تحصن في مكة المكرمة فحاصرت جيوش يزيد مكة المكرمة وأحرقت الكعبة
مات يزيد منذ 1336 عاما ولم تمت الأحقاد والضغائن والكراهية والجهل بل ازدادت جهلا وظلاما
يرقد ما تبقى من الحمض النووي ليزيد في مكان ما بعد أن نبش العباسيون قبره عندما انتصروا على الأمويون وطاردوهم الى الأندلس
وتبقى قصيدة شعر يزيد تدندن بحب سليمة العامرية مختلطة مع أصوات ثارات ولطميات الحسين
أصابَكَ عشقٌ أم رُميتَ بأسهمِ
فما هذه إلا سـجيّـةُ مُغـــرَمِ
ألا فاسقِني كاسـاتِ راحٍ وغنِّ لـي
بذِكـرِ سُــليـمــه والكمانْ ونغِّـني
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني
رأيتُ بعيني في أناملها دمي
أيا داعيا بذكر العامريةِ إنني
أغارُ عليها من فم المتكلمِ
أغارُ عليها من أبيها وأمِـهـا
إذا حدّثاها في الكلامِ المُغَمغَمِ
أغار عليها مـن أبيهـا وأمـهـا
ومن خطوة المسواك إن دار في الفم
أغار على أعطافهـا مـن ثيابهـا
إذا ألبستهـا فـوق جسـم منْـعـم
وأحسـد أقداحًـا تقـبّـل ثغرها
إذا أوضعتها موضع اللثم فـي الفـم
فوالله لو لا الله والخوف والرجا
لقبلتها بين الحطيم وزمزم
فان حرم الله الزنا في شرعه
فما حرم التقبيل في الخد والفم
فان حرمت يوما على دين أحمد
فخذها على دين المسيح ابن مريم
Aleppo becomes ‘problem from hell’ with U.S. Inaction
An article in The San Diego Union-Tribune posted on December 22, 2016
Link to the article
UN. Secretary General Ban Ki Moon has called my hometown of Aleppo a synonym of hell. “The Problem from Hell,” the title of U.S. Ambassador to the U.N. Samantha Power’s award-winning book, intended to describe the U.S. inaction in Bosnia, now describes my hometown of Aleppo. Despite six years of empty rhetoric, my city is currently witnessing sectarian cleansing that has ironically unfolded under Ms. Power’s own watch.
In the past week, I have spoken to family and friends inside Aleppo as I watched reports of the Assad regime killing entire families all at once, women committing suicide to avoid being raped by Assad’s forces, young men being rounded up and continued indiscriminate airstrikes.
I can’t help but dwell over the number of times this administration has made statements that it did not follow with action.
The rising isolationist sentiment in the U.S. may appear as a reasonable justification for the Obama administration abrogation of the Syrian people’s rights to a representative democracy.
However, the Obama administration was by no means Switzerland when dealing with Syria. The Obama administration implemented one of the largest covert CIA programs ultimately contributing to the destruction of Syria while, intentionally or otherwise, ensuring the survival of an Assad dictatorship.
To add insults to our overwhelming pain, President Obama mocked the suffering of the Syrian people during a recent news conference by essentially saying he could not hold his red line “on the cheap.” As if he knows the ultimate price of 500,000 murdered civilians, 12 million displaced refugees and the resulting destabilized Middle East and Europe.
In 2012, I met Ms. Power at the White House, informing her of my fears that Assad would follow through on his threats to annihilate his population like germs. I, among other Syrian-Americans, was assured at the time that the United States stands with freedom and democracy and would never allow massacres to happen.
At that time, none of us Syrian-Americans fathomed that a U.S. president would talk big and loud but carry a toothpick.
In his Nobel Peace Prize acceptance speech in 2009, Mr. Obama made the following statement, “Inaction tears at our conscience and can lead to more costly intervention later.”
His words have proved true, six years into missed opportunities of inaction that empowered the Assad regime’s mass atrocities against the Syrian people. If Mr. Obama’s words have meanings then he must have concluded that “more costly intervention later” is better strategy than limited actions now.
Obama has stood idly by and allowed Assad and his partners, Iran and Russia, to create the largest humanitarian and refugee crisis since World War II. His inactions created the power vacuum that allowed the rise of extremist Islamist organizations like ISIS who are now threatening the globe and granted the ayatollah of Iran hegemony over Southwest Asia extending from Afghanistan to the Mediterranean.
Today, over 100,000 civilians are being religiously cleansed from eastern Aleppo primarily by Iranian and Hezbollah mercenaries under a cease-fire agreement brokered by Russia and Turkey. Russian air power coupled with Iranian-backed militias now play a central role in enforcing Syria’s sieges and both countries participate in overseeing local forces surrender and displacement negotiations.
The pictures of thousands of the people of my city being forcibly displaced from their homes for no crime but seeking liberty are a stain on the world conscience. The world made a commitment of “never again” after the Holocaust, Srebrenica and Rwanda. Make no mistake, President Obama can end these mass atrocities with a single credible threat of force to push the regime to stop massacring civilians, yet he refuses.
As President Obama watches on while Syrians are slaughtered and are subjected to forced displacement, Ms. Power’s old “problem from hell” is now a reality and yet to be a written history. In her book, she wrote about the refusal of public officials to even resign in protest of the Clinton administration’s inaction in the Balkans, yet she continues to serve in an administration that refuses to act.
The least Ms. Power can do for Aleppo is to resign in protest of this shameful policy. History will record her, like Obama, as complicit in these crimes against humanity.
Alagha, a longtime resident of San Diego County, is national chairman of the Syrian American Council, a nonprofit Syrian American advocacy organization that advocates for a free and democratic Syria. The organization’s website is http://www.sacouncil.com.
أهل الشام
منذ بدء التاريخ كان و لايزال “التاريخ” و لاتزال “الجغرافيا” نقمة ظالمة علينا.
نحن أهل الشام نسينا أو تجاهلنا تاريخنا المرير منذ سقوط الخلافة الأموية. مانجهله هو الحقيقة التاريخية أننا لم نحكم ذاتنا بدولة موحدة تمثل أغلبية أهل الشام سوى فترة قصيرة من تاريخنا الدامي. كنا و لانزال إلعوبة بيد القوى الطائفية و العرقية سواء كانت محلية أو عالمية. فبعد الخلافة الأموية كان البرامكة الفرس مصدر قوة الخلافة العباسية في زمن هارون الرشيد و المأمون الى أن إستطاع المعتصم أن يستبدلهم بالسلاجقة الأتراك. لم تمضي عقود قليلة حتى سيطر الأتراك بالكامل على مقاليد الحكم في الخلافة العباسية. خلال فترة إضمحلال الخلافة العباسية، تبادل الصليبيون و المغول و الفاطميّون و المماليك حكم الشام الى أن سيطر العثمانيون عليها. الآن و بعد قرن على ثورة لورانس الإنكليزي على الأتراك لا نزال إلعوبة بين فرس و روم و سلاجقة و تتار العصر الحالي. وهاهنا نحن بالإضافة الى نقمة الجغرافيا لا نزال نصارع غِلّ هذا التاريخ المرير. في قرن من الزمن، إستطاعت العديد من الشعوب التي كانت خلفنا أن تتطور و تسبقنا في الحضارة و الإقتصاد بينما لانزال نناطح التاريخ في محاولات ساذجة لتدوير عجلة الزمن الى الوراء.
الثورة لم تعرّي فقط نظام القتل و الإستبداد بل فضحت رياءنا تحت مسميات الأمة العربية التي لم تكن متحدة واحدة حتى في عصرها الذهبي أو الأمة الإسلامية لم تكن متوحدة واحدة منذ طعن أبو لؤلؤة المجوسي غدرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل سوف نُضِيعُ جيل جديد في الدائرة المغلقة بين الإستبداد و التطرّف الجاهل.
ماهو الحل؟.
رغم تهافت القوى المحلية و العظمى علينا، لا يمكن عزل التغيير السياسي عن التطور الإجتماعي و الحضاري.
هل البداية في تغيير المجتمع وصناعة عقد إجتماعي جديد؟.
في كتابه “سياسة التغيير الإجتماعي في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا” يقول مانفريد هالبيرن (١٩٦٣) أن التغيير في الشرق الأوسط سوف يبقى من ثورة الى ثورة تُعيد تشكيل نفس نظام الحكم بأطر و أيديلوجية مختلفة مع عدم المقدرة على تغيير الواقع. حيث أن التحول الأساسي ليس مجرد تبادل أنظمة الحكم بل تغيير عقلية و عقائد المجتمع وكيف تتحول العقائد الى أفعال و كيفية يتعامل ويتفاعل الأفراد و المجتمعات مع بعضها البعض.
أم أن البداية في تغيير أنظمة الإستبداد؟.
في كتابه الشهير “طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد” يقول عبد الرحمن الكواكبي: “فالقائل مثلا: إن أصل الداء التهاون في الدين، لا يلبث أن يقف حائرا عندما يسأل نفسه لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل: إن الداء اختلاف الآراء، يقف مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف. فإن قال سببه الجهل، يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد … وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول: هذا ما يريده الله بخلقه، غير مكترث بمنازعة عقله ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم …. وإني إراحة لفكر المطالعين أعددت لهم المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلها وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها، وبذلك يعلمون أني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجح أني قد أصبت الغرض. وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي”
بعد أكثر من قرن كامل على توصيف الكواكبي للإستبداد السياسي المتولد من الإستبداد الديني، ها نحن نعيش إستبداد علماني تحت شعارات محاربة الإرهاب الكاذبة. لا تزال هذه الدائرة المفرغة تدور بين إستبداد وتطرف طائفي أو عرقي تضمحل فيها قوى الإعتدال و الوسطية. إن أهم أسباب نجاح تيار الإستبداد المناهض للربيع العربي يعود الى إنهيار المجتمعات العربية خصوصا في كيفية تحول العقائد الى أفعال و عدم الثقة بين مكونات المجتمع. ضياع الثقة أضاع إمكانية تعامل وتفاعل الأفراد و المجتمعات مع بعضها البعض.
تحدياتنا واضحة: إستبداد، إنهيار العقد الإجتماعي، تاريخ دامي و جغرافيا ظالمة و لايمكن الخروج من هذه الدوامة سوى بإعادة بناء حضارة الإنسان قبل جاهلية الأيديولوجيات. هل بإمكان المجتمع السوري تجاوز التناقضات الواضحة التي ظهرت على السطح خلال ال ٧ أعوام منذ بدء الثورة السورية الكبرى وخصوصا” تناقض المعرفة الفكرية مع الواقع الإجتماعي السوري المؤيد للثورة.
في بداية الثورة كانت هناك “معرفة فكرية” أصفها كالتالي:
دكتور علم النفس الإجتماعي التركي المشهور “مُظفر شريف” إشتهر بتجربه “كهف اللصوص” والتي إستنتج منها أن طبيعة الجماعات أن تختلف و تتصارع وهذا جزء من الطبيعة البشرية و عصبيتها لجماعتها. ثم إستنتج أن هذه الجماعات المختلفة تستطيع التعاون و التسامح و الإندماج عندما يتواجد عدو خارجي يهددها و عند تواجد أهداف مشتركة. البروفيسور مُظفر شريف هو أحد مؤسسي “نظرية الإختلاف الواقعي” والتي تتوقع أن تتجاوز الجماعات إختلافاتها إن كان هناك هدف مشترك أو عدو مشترك.
واقعنا الحالي و فشل كل محاولات “الغربلة” أوصلني ل “معرفة واقعية” تقول:
منذ ٢٠١١، كنت أتوقع أن عملية “الغربلة” أو الإنتقاء الطبيعي للقيادات بالإضافة الى الألم المشترك سوف تُنهي الخلافات العميقة بين المؤسسات الثورية السياسية و العسكرية و المدنية. كنت مخطئ تماما في توقعاتي فقد أصبح واضحا الأن أن عملية تدمير المجتمع السوري التي بدأت في أوائل الستينات من القرن الماضي قد أتت ثمارها. العدو المشترك و الهدف المشترك لن يُغَيِّر العقلية السورية التي ولدت و ترعرعت على منطق “عدم الربح خسارة” و “الثقة في أي شخص غير الذات غباء”. كنت أظن أن مشكلتنا تُحل ضمن عملية غربلة، للأسف مشكلتنا أعمق و أصعب و طريقنا طويل. يبدأ تغيير الإستبداد بتغيير الذات.
صدق نزار حين قال:
خلاصةُ القضيّهْ
توجزُ في عبارهْ
لقد لبسنا قشرةَ الحضارهْ
والروحُ جاهليّهْ…
هل تصنع الثورة عقد إجتماعي جديد
دراسة “أبعاد هوفستد” حول المجتمع السوري.
في الستينات و السبعينات من القرن الماضي، كان عالم النفس الهولندي جيرت هوفستد يعمل لدى شركة أي ب م في فرع الموارد البشرية (التوظيف). خلال عمله، طور نظام تصنيفي لكيفية تعامل الحضارات و الثقافات المختلفة مع العمل المشترك الجماعي و عمل فرق العمل. منذ ذلك الوقت، تم تطوير هذه التصنيفات و إليكم ترجمة التصنيف الحالي للشعب السوري مع المصدر.
———————–
إذا كنا نريد استكشاف الثقافة السورية من خلال عدسة سداسية الأبعاد فيمكننا الحصول على لمحة جيدة من الدوافع العميقة للثقافة السورية بالمقارنة مع ثقافات العالم المختلفة.
البعد الأول – مسافة السلطة
هذا البعد يتعامل مع حقيقة أن أغلب الأفراد في المجتمع السوري ليسوا على قدم المساواة – وهي تعبر عن الموقف الثقافي للشعب السوري تجاه هذه الفوارق. ويُعرف مفهوم “مسافة السلطة”، إلى أي مدى يوافق أعضاء المجتمع السوري الأقل قوة ضمن المؤسسات والمنظمات السورية أن توزع السلطة على نحو غير متكافئ.
علامة مسافة السلطة في سوريا هي 80 مما يدل أن المجتمع السوري هو مجتمع هرمي. وهذا يعني أن الناس يوافقون عموما على ترتيب هرمي فيه لكل شخص مكان و موقع محدد ولا يحتاج هذا الترتيب الهرمي الى تبرير. وينظر إلى التسلسل الهرمي في المنظمة، على أنه يعكس عدم المساواة المتأصل، و المركزية لها شعبية، ويتوقع المرؤوسين أن يُقال لهم ما يجب القيام به ويتوقع المجتمع أن يكون الرئيسالمثالي هو المستبد الخّير.
البعد الثاني – الفردية
القضية الأساسية التي يتناولها هذا البعد هو درجة الترابط بين المجتمع و أفراد المجتمع. هل صورة التعريف الأساسي في سوريا هو “أنا” أو “نحن”.
في المجتمعات الفردية من المفترض على الناس الاعتناء بأنفسهم والأسرة المباشرين فقط.
في المجتمعات الجماعية ينتمي الناس إلى ‘مجموعة’ أو جماعة على أن تعتني هذه المجموعة بهم في مقابل “الولاء”.
درجة الفردية منخفضة الى 35 و في تحليل هذا البعد يعني أن سوريا تعتبر مجتمع “مجموعات”. وهذا واضح في الإلتزام الشديد وطويل الأجل “للجماعة” سواء كانت الأسرة، أو الأسرة الممتدة، أو علاقات ممتدة.
“الولاء” في هذه الثقافة الجماعية هو الهدف الأسمى ويتجاوز القواعد والأنظمة المجتمعية الأخرى. المجتمع يعزز علاقات قوية حيث يأخذ الجميع مسؤوليته عن زملائه أعضاء جماعتهم. في المجتمعات الجماعية: الخطئ يؤدي إلى العار وفقدان ماء الوجه، ويُنظر إلى علاقات صاحب العمل / الموظف في الناحية الأخلاقية (مثل وصلة الأسرة) والتعيين وقرارات الترقية تأخذ في الاعتبار دور الموظف في الجماعة بشكل أهم من الصفات و الكفائات الفردية.
البعد الثالث – الذكورة
إن درجة عالية (مذكر) في هذا البعد تعني أن دوافع المجتمع الأساسية هي المنافسة والإنجاز والنجاح، مع النجاح الذي حدده الفائز / الأفضل في الميدان – و هذا يُبنى على نظام القيم الذي يبدأ في المدرسة ويتستمر طوال الحياة التنظيمية.
أما درجة منخفضة (المؤنث) في هذا البعد فهي تعني أن القيم السائدة في المجتمع تتعلق في الأهتمام بالآخرين وجودة الحياة. مجتمع المؤنث هو مجتمع فيه نوعية الحياة هي علامة على النجاح و الوقوف خارج التيار ليس مثير للإعجاب. القضية الأساسية هنا هو ما يحفز الناس، يريد أن يكون أفضل (مذكر) أو أن يحب عمله (المؤنث).
علامة هذا البعد في سوريا، هو درجة وسيطة من 52، لا يوجد تفضيل بشكل واضح في هذا البعد.
البعد الرابع – تجنب عدم اليقين أو ( تجنب الشك)
هذا البعد، “تجنب عدم اليقين”، له علاقة مع الطريقة اللتي يتعامل فيها المجتمع مع حقيقة أن المستقبل لا يمكن أبدا أن يكون معروف النتائج. هل يجب علينا محاولة السيطرة على المستقبل أو مجرد السماح لما سوف يحدث أن يحدث؟
هذا الغموض يجلب القلق معه، ولقد تعلمت ثقافات مختلفة طرق مختلفة للتعامل مع هذا القلق.
إلى أي مدى يستطيع أعضاء المجتمع السوري صناعة المعتقدات و المؤسسات التي تحاول تجنب المستقبل المجهول عندما يشعرون بأنهم مهددون من قبل أمور خطيرة أو غامضة أو مجهولة وتنعكس هذه المقدرة في النتيجة الإجتماعية على تجنب عدم اليقين.
إن ارتفاع درجة “تجنب الشك” الى 60 في هذا البعد هو دليل أن المجتمع السوري لديه تفضيل عالي لتجنب عدم اليقين. الدول ذات علامة مرتفعة لبعد “تجنب عدم اليقين” تُصر على الحفاظ على رموز جامدة في العقيدة والسلوك و هي غير متسامحة لأي سلوك وأفكار غير تقليدية. في هذه الثقافات هناك حاجة عاطفية لقواعد العمل و التصرف (حتى لو كان واضحا أن هذه القواعد لا تعمل أبدا)، هناك إرتباط قوي بين الوقت و المال، والناس في هذه المجتمعات لديهم رغبة داخلية أن يكونوا مشغولين في العمل الجاد، والدقة والالتزام ولكنهم يرفضون الإبتكار والأمن هو عنصر هام في الدافع الفردي.
البعد الخامس – التوجه نحو المدى البعيد
يصف هذا البعد كيف يحافظ كل مجتمع على بعض الروابط مع ماضيه في التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل، والمجتمعات تضع أولويات مختلفة لهذين الهدفين الوجوديين و بشكل مختلف.
المجتمعات المعيارية التي تسجل انخفاض في هذا البعد، على سبيل المثال، تفضل الحفاظ على التقاليد والأعراف العريقة و تنظر الى التغيير المجتمعي بعين الشك.
أما المجتمعات التي تُسجل درجات عالية في هذا البُعد، من ناحية أخرى، فإنها تتخذ نهج أكثر واقعية إذ أنها تشجع الادخار والجهود المبذولة في التعليم الحديث كوسيلة للإعداد للمستقبل.
إن الدرجة المنخفضة (30) في هذا البعد يعني أن سوريا هي، إذن، تحمل الثقافة المعيارية. الناس في مثل هذه المجتمعات لديها اهتمام قوي في الوصول الى الحقائق المطلقة. و هم “معيارين” في تفكيرهم. كما أنهم يظهرون احتراما شديدا للتقاليد مع الميل القليل نسبيا إلى الادخار للمستقبل، والتركيز على تحقيق نتائج سريعة.
البعد السادس – تَنَعَّمَ
مقدرة المجتمع على التحكم بعواطفه و رغباته. في هذا البعد تُصنف المجتمعات أما “متساهله” أو تحتوي قدرة واسعة على “ضبط النفس”. لا يوجد علامة للمجتمع السوري حاليا من المصدر.
https://geert-hofstede.com/syria.html
أربعة أشياء نعرفها عن كيف تنتهي الحروب الأهلية
مقالة مترجمة لدكتورة العلوم السياسية باربارا والتر – تاريخ المقالة تشرين الأول 2013

تواصل إدارة أوباما على أن تصر على أنها ترغب في رؤية حل دبلوماسي للحرب الأهلية في سوريا. ولكن هذه الرغبة تتناقض في مواجهة كل ما تعلمناه حول كيف قد انتهت الحروب الأهلية خلال السنوات 70+ الماضية. وهناك أربعة أشياء يجب على الرئيس أوباما أن يأخذها في الاعتبار كي يرى الجدوى من الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية في سوريا
أولا:
الحروب الأهلية لا تنتهي بسرعة. وكان متوسط طول الحروب الأهلية منذ عام 1945 حوالي 10 أعوام. وهذا يشير إلى أن الحرب الأهلية في سوريا هي في مراحلها المبكرة، وليست في المراحل النهائية والتي تدفع إلى تشجيع المقاتلين للتفاوض على تسوية ما
ثانيا:
كلما زاد عدد من الفصائل، كلما طالت مدة الحروب الأهلية. تدور حرب اهلية في سوريا بين حكومة الأسد ولا يقل عن 13 من الجماعات المتمردة الرئيسية ضمن تحالفات هشة نسبيا. هذا يشير إلى أنه من المرجح أن تستمر الحرب الأهلية في سوريا لفترة أطول من الحرب الاهلية في المعدل (أكثر من 10 سنوات)
ثالثا:
حسب الإحصائيات، معظم الحروب الأهلية تنتهي بانتصارات عسكرية حاسمة، وليس بتسويات عن طريق التفاوض. في تاريخ هذه الحروب، قد فازت الحكومات حوالي 40٪ من الوقت، وفاز الثوار حوالي 35٪ من الوقت. ما تبقى تميل إلى وضع حد للقتال عن طريق التفاوض. وهذا يشير إلى أن الحرب الأهلية في سوريا على الأغلب لن تنتهي في تسوية عن طريق التفاوض ولكن سوف تنتهي في ساحة المعركة
رابعا:
وأخيرا، فإن الحروب الأهلية التي تنتهي عن طريق التفاوض بنجاح تميل إلى أن تتميز في شيئين. أولا، فإنها تميل إلى تقسيم السلطة السياسية بين المقاتلين على أساس موقفهم العسكري في ساحة المعركة. وهذا يعني أن أي تسوية عن طريق التفاوض في سوريا ستحتاج لتشمل كلا من نظام الأسد والإسلاميين، ولكن لا أحد منهم يهتم بشكل خاص في العمل مع الآخر. ثانيا، اتفاقيات التفاوض الناجحة تحتاج الى مساعدة من طرف ثالث يكون مستعدا لضمان سلامة المقاتلين في المرحلة الانتقالية. هذا يعني أنه حتى إذا وافقت جميع الأطراف في نهاية المطاف للتفاوض (أي بسبب الجمود العسكري أو تكاليف باهظة على نحو متزايد)، فإنه من غير المحتمل أن أي دولة أو للأمم المتحدة سوف تكون على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام اللازمة للمساعدة في تنفيذ السلام.
ولهذا احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية ناجحة في سوريا؟ ربما تقترب من الصفر
أين هم أهل الوسط
أطلق عليها إبن خلدون إسم “العصبية” و تدعى في المفهوم الغربي الإنتماء وهي الأرضية الأساسية و الأهم لأية مجتمع و أية دولة. الواقع المرير أن المتطرفون و الأقليات هم فقط من إستطاعوا تكوين قيادة مركزية و عسكرية موحدة بينما فشل الجميع ممن يدعون “الوسطية”. داعش تملك قيادة عسكرية و سياسية مركزية. النصرة لها برنامجها السياسي و العسكري المركزي. الإحتلال الإيراني و الروسي و الفصائل الطائفية الشيعية تملك قيادة مركزية موحدة. الكرد يملكون قيادة مركزية سياسية وعسكرية تبحث عن دولة مستقطعة من الجسم السوري
الجميع يدعي الوسطية و هنا قلب و مركز المشكلة، نتخاطب من منطلق وسطي معتدل يشاركك فيه أغلب الشعب السوري و لكننا جميعا (أهل الوسط) قد فشلنا في تكوين قيادة معتدلة عميقة لها بعد سياسي و عسكري مركزي. هل لأننا نكذب على أنفسنا ونحن في الواقع لا نملك إنتماء يوحدنا لأننا مجرد طوائف و قبائل و مصالح أولاً و سوريون بالصدفة؟
نحن نحتاج أن نصنع حلول عملية ولم يبقى وقت لنظريات المثقفين من أبراجهم العاجية. تكفي زيارة واحدة للملايين في مخيمات اللجوء لتسقط الثقافة
في بداية الثورة كان واضحاً أن النظام غير قادر على حسم الصراع ولم يكن قادر أن يشارك المعارضة في السلطة شراكة حقيقية لأن المشاركة تعني نهاية النظام المركزي الهرمي. مشكلتنا الحالية أكبر و أعمق من النظام مهما كان شكله. إن إستعباد و إستبداد الأسد قد دمر العقد الإجتماعي السوري و منع الصناعة الطبيعية لنخبة قيادية وسطية تتسع للجميع. النُخب المصطنعة للمعارضة منذ بداية المجلس الوطني الى الفصائل العسكرية المتناحرة لم تكن مؤهله أو قادرة على العمل الجمعي المنتظم. لقد تحقق النصر للثورة فقط عندما توحدت الفصائل العسكرية و نأمل أن يستطيع نشطاء الثورة و سياسييها و كل من يعمل من أجلها أن يكونوا بمستوى التضحيات و المسؤولية و أن يبتعدوا عن المهاترات و التحصن في مواقع الخلافات الأيديولوجية و أن يتوحدوا ضمن أُطر تتسع للجميع. فما هو الحل بعد التمني؟
الحل هو خلق “جبهة إنقاذ سورية” تتألف من قيادة سياسية و عسكرية مترابطة معا و قادرة أن تُجمع الداخل و أن تتعامل و تتفاوض من منطلق وطني موحد مع القوى الخارجية و من بقي من أشلاء النظام. هل يمكننا بناء قيادة وسطية موحدة كهذه؟ لا أعتقد أننا سنتغير بين ليلة وضحاها و يصعب تكوين جبهة موحدة في المدى القريب لأن الثورة أظهرت حقيقتنا، هناك نسبة واسعة من أهل “الصفوة” أو النخبة تضع مصالحها الشخصية أولاً و قد نجح نظام الإستبداد من تمزيق أي شكل ل “عصبية” وطنية سورية تعلوا و تسبق باقي الإنتماءات
بقاء الأسد في السلطة كان و لايزال أهم من بقاء سورية عند مؤيديه و حروب الطوائف و المصالح الحالية و القادمة سوف ترسخ الإنتماءات الضيقة و الطائفية و التطرف. أهمية الثورة ليست مجرد تغيير النظام بل تغيير كل فرد منا. إن لم تعيد الثورة صناعة عقليتنا و لم تُعلمنا أهمية “وطن” يتسع للجميع بكل ما تحتويه الكلمة فإن مأساتنا الحالية و التاريخية سوف تستمر. بعد تدمير الإنسان و المدن و القرى و تهجير أو قتل الملايين فإن كل من يعتقد أن أي حل عسكري أو إتفاق سياسي سوف يحقق الإستقرار يجب أن يكون مصاب في الهذيان؟. يا أهل الوسط، إتحدوا
The fallacy of a self-professed prophecy
If you say it enough, they will believe it. The Arab world cannot establish modern, representative and tolerant democracies and therefore its masses must be ordained to live under brutal dictatorships. In his last and final state of the Union speech, President Obama reiterated the underlying justification for such belief: “The Middle East is rooted in conflicts that date back millennia”. It is an argument constantly propagated by orientalists, politicians and western thinkers. This fallacy typically concludes with a simple prophecy, that the region will forever remain mired in conflicts. What has been missing from the debate is the most important factor, power. Who has it, how is it being exercised and for what purpose. Change, whether positive or negative, is achieved when the balance of power reaches a tipping point.
They have been fighting for generations. Both the ultra-right tea party and ultra-left progressive spectrum of the American political elite embrace this fallacy with para-religious zeal. Unlike American politicians, Middle Eastern tyrants fully understand the social underpinnings of regional conflicts and are much more skillful in using the instruments of power to survive. Middle Eastern tyrants are especially renowned for their ability to manipulate and exploit the west fear of extremist Islamists to maintain their repressive regimes.
Take the Syrian tragedy as an example, pundits talking or writing about Syria are often quick to dismiss facts and adopt the same condescending justification: Culturally, ethnically or religiously, Syrians are doomed to remain in perpetual conflicts. However, the historic facts are quite different. Three snapshots in time are important to illustrate this point, years 1919, 1949 and 2012.
About 100 years ago, President Woodrow Wilson established the King-Crane Commission to assess the sentiments of the people of greater Syria concerning the future administration of their affairs. The commission conducted the very first public opinion survey in the Levant in the summer of 1919. The overwhelming sentiment was for American oversight over the affairs of greater Syria instead of Imperial British or French mandate. The commission recommended US mandate over the region, US Congress and Wilson administration ignored the commission recommendations. A lost opportunity, the US government was unwilling or incapable of using its influence or power to affect timely positive change. It is noteworthy that the King-Crane commission did not mention or come across any radical Islamist group even during the last days of the Ottoman Caliphate This raises the question of which forces and policies later brought radical Islam into existence and into the foreground of the world’s preoccupations.
Britain and France ended up dividing the area among themselves. France occupied Syria from 1920 until 1945. After independence from the French mandate, Syria maintained a functioning representative democracy for 18 years. A CIA arranged coup in 1949 interrupted Syria’s first democratic experiment bringing Hosni Alzaim to power as the first dictator after independence. In this case, the US government was successful in using its influence and power to affect change in Syria, the change introduced a chain of military dictatorship, a change for the worse?
Looking back, we may justify this first coup as a direct result of the geopolitical struggle against the USSR. By such justification, we ignore the fact that the sole purpose of the coup was to ensure the construction of the now defunct Trans-Arabia oil pipeline. The coup started a chain of military coups, however, a relatively healthy representative democracy flourished until the arrival of the Ba’ath party. Regardless as to the justification for the CIA coup, the fact remains, starting 71 years ago, the Syrian people were able to maintain tolerant representative democracy. This fact exposes the ideological demagoguery of those who insist that Syrians are religiously or genetically unfit to build and maintain a democratic governance. During these 18 years after independence, the historic facts are indisputable, democracy allowed Syrians to overcome sectarian distrust, struggle or conflict. Syrians even elected a famous Christian prime minister named Faris Khoury. In spite of the current shameful mayhem, sectarian strife and atrocities, this short-lived democracy between 1945 and 1963 is a shining example of the inherent tolerance of the Syrian people. Until this day, Mr. Khoury achieved the highest political position any Syrian Christian has ever reached. Those who now defend Assad as the protector of minorities in Syria should be ashamed of themselves, dictators are divisive by definition and modern democracies are the only true protectors of pluralism and minorities.
In May 2012, President Obama overruled the advice of his entire cabinet by deciding to abandon Syria to Iran, Russia and extremists. The failure of Iraq’s “alliance of the willing” made the Obama administration, and justifiably so, unwilling to commit troops in the Middle East. However, boots on the ground are a far cry from using US influence to tip the balance of power in Syria toward democratic forces. The administration argument is succinct but startling: “To support the transition from tyranny to democracy, we must first be assured of an outcome serving our own self-interest but without any meaningful exercise of power or influence”. This argument is leading Syria and the region either to the abyss of tyranny or to a protracted heaven for extremists. What rather enlightened, soft power, leading from behind, realpolitik logic accepts such an outcome? Only Obama and his ideologue advisors know.
One will naturally ask why ISIS, Al-Qaida and other extremist groups are so prevalent in Syria now. Religiously based political ideology is a precise but inaccurate answer. Yes, a small minority of Sunni Muslims are religious fanatics who justify ISIS and Al-Qaida crimes based on disputed theological underpinning. However, the creation of entities such as ISIS demands Machiavellian exercise of power not just a theological dispute about a religious text. One must then ask what powerful forces empowered these groups, how and for what purpose. In stark contrast to the Syrian uprising, let us explore where peace and tranquility prevail nowadays then ask who, how and why.
In Western Europe and Japan, it was American power in defeating the Nazi axis. In Eastern Europe. American perseverance led to the collapse of the USSR. In South America, it was American leadership in defeating communism. In South Korea, it was America standing up to tyranny. South Africa achieved peace after unprecedented international pressure against the apartheid state, led by America. Even in China, it was President Nixon extending a hand of friendship and economic opportunity. American power and leadership made all the difference in the last 100 years. Powerful nations and empires shaped history and throughout history, the answer to the following question was all that matters: How did those who hold power exercise it? Was it for good, for evil or for indifference?
Tyrants and extremists have a very deep symbiotic relationship. The extremists in Syria need Assad to recruit and Assad needs extremists to survive. Prognosis is the first step needed to find a cure for any ailment including the disease of dictatorships and extremism. It is incumbent upon thought leaders to go beyond prognosis and identify a cure. In political and social science, just like in medicine, symptoms are sometimes confused with causes. The golden rule in medicine is this: Cure the disease, do not just treat its symptoms. The exact truth holds in political and social settings: Eradicate dictatorships, do not just blame and fight its symptoms.
عقد إجتماعي جديد
في بلاد العرب، لايزال هناك من يؤمن بإن قيادة الحاكم المتسلط والعادل والحكم المركزي الهرمي هي الطريقة المثُلى للحكم الرشيد وهي القيادة التي ستُمكن بلادنا من أن تنهض وتتقدم
تجاربنا منذ قرن قد أثبتت أن إنتظار شعوبنا للحاكم الصارم المتسلط ولكن العادل قد طال حتى أصبحت بلادنا في حضيض الحضارة
منطق الحكم المركزي الهرمي هو مهنة محلية تمارسها كافة الإتجاهات والأيديولوجيات في بلادنا وهو منطق ذو أسس اجتماعية وحضارية يصعب تغييرها. شعوبنا لم تصل بعد الى تجارب سياسية تستطيع من خلالها التخلص من الأهرام التي تحتوي القائد الفذ أو الحزب المجيد على قممها. مما لاشكفيه تاريخياً أن كل الأحزاب سواء كانت قومية أو إسلامية أو يسارية أو ليبرالية لم تُنتج سوى أنظمة سياسية تتلخص وتُختصر بشخص واحد أو عائلة واحدةولم تستطع أن تنهض ببلادها بعد نصف قرن من حكم الشخص الأوحد. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا سؤال مهم للغاية: لماذا يتفق الجميع في بلاد العرب من اليساريون والليبراليون والقوميون والإسلاميون على أنظمة حكم تنتهي بالسلطة المطلقة بيد شخص واحد أو فئة صغيرة؟ هل هذا مجرد نتيجة مباشرة لمفاهيم إجتماعية وحضارية تربوية عميقة يصعب تغييرها أم أن السبب هو مراكز القوى العالمية التي تفرض على شعوبنا الحكم المطلق الهرمي؟
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة فهل من مخرج؟ ما هو الحل من هذا الإرث التاريخي والمرض الإجتماعي الذي أصاب بلادنا. يتسابق العديد لطرح حلول من منطلقات أيديولوجية بحتة. فبعض الإسلاميون يرفعون شعار أن الإسلام هو الحل ويتنافس القوميون في صراعات عدمية حول أولوية الوحدة القومية أو القطرية. بينما تقوقع الماركسيون مع تراجع الشيوعية ولايزال الليبراليون يَرَوْن الحل هو مجرد إستيراد ونسخ للتجارب الغربية. يستمر جدل مثقفي البرج العاجي بينما يتقوقع أغلب المجتمع حول إنتمائات طائفية أو قبلية أو أثنية أو مناطقية.
التغيير من أنظمة هرمية عامودية الى نظام تعددي أفقي لا يحتاج الى أيديولوجيات سياسية بقدر الحاجة الى ضبط وتوزيع السلطة المركزية مهما كانت إنتمائاتها. يوجد محورين أساسيين لصناعة التغيير المبتغى
١– السلطة المحلية: وهي تختلف عن مجرد الإدارة المحلية. يقال في الغرب أن “السياسة المحلية هي كل السياسة” بمعنى أن كل الإهتمامات الأساسية لأية مجموعة بشرية هي ذات أولويات محلية. ولكن حكومات الإستبداد لن تسمح للقوى المحلية أن تدير أمورها الذاتية بنفسها لأن هذا يُضعف مصادر دخل ونفوذ الإستبداد. وبما أن مجتمعات الشرق الأوسط لا تمتلك إنتمائات وطنية مشتركة بل تُصر على إنتمائات طائفية أو أثنية فإن السلطة المحلية قد تتحول بسرعة الى صراع مع الجوار والى تفتت وتشرذم معاكس لتطور الأنظمة البشرية. وهكذا ثلاث مُعيقات لبناء سلطة محلية متطورة، المواطنة الضائعة، والإستبداد، والصراع بين مكونات المجتمع. الحل يتم عندما يمتلك جزء واسع من الشعب حضارة تقبل الأخر وعقلية ضبط حدود الخلاف
٢– المؤسسات و المنظمات المدنية: استولت أنظمة الإستبداد على كافة المؤسسات و المنظمات المدنية و منعت إنشاء أو نمو مؤسسات مستقلة. كان العمل السري هو الحل الوحيد لمواجهة استيلاء الأنظمة على المؤسسات المدنية. الدور الأساسي للمؤسسات المدنية الحرة هو أنها تنتقي الكفائات وتصطفي القيادات الصادقة. ألية صعود النخبة القيادية الصادقة في الأنظمة الحرة هي أهم عوامل التطور
يقول توماس فريدمان وهو كاتب أميركي مشهور في مقالة حديثة في جريدة النيويورك تايمز أن سبب فشل العرب من أن يصنعوا دولة معاصرة هو أمرين أساسيان
١- لايوجد ألية تُعلم الشعب كيفية تحمُل أو تَقبُل الخلاف أو الإختلاف و
٢- لايوجد قيادات صادقة قادرة أن تنقل المجتمع من الواقع الى الأفضل؟
طبعاً لم يعترف فريدمان ولن يعترف أن التدخل العدواني للدول الخارجية وخصوصاً الغربية في شؤون شعوب ودول المنطقة هو أحد أهم أسباب هذا الفشل. ولكن هذا لا يعني أنه مخطئ في توصيفه لثنائي الأسباب التي أفشلت التطور العربي. تٓقبُل الخلاف هو حجر الأساس للمواطنة. و ألية تصطفي القيادة المؤهلة والصادقة والتي لا تملك سلطة مطلقة هي الوحيدة التي تستطيع أن تنقل مجتمعاتنا الى الأمام
الدين و الدولة
مع فشل التجارب القومية والليبرالية والاشتراكية في الوطن العربي، مهما كانت أسباب ومبررات الفشل، ظهر دور الإسلام السياسي كأضخم تيار شعبي في الوقت المعاصر. إن دور الإسلام في المجتمع والسياسة في منطقة الشرق الأوسط هو واقع لا يُصح ولا يُمكن تجاوزه
كثُر في وقت الربيع العربي الجدل العقيم حول الحكم الإسلامي والعلمانية وكأنه خيار بين جنه ونار؟ مفهوم فصل الدين عن الدولة هو مفهوم غربي ناتج عن تاريخ علاقة الكنيسة الكاثوليكية مع ملوك وأمراء أوربا في القرون الوسطى. منذ الهجرة النبوية، ارتبط تاريخ الإسلام ارتباطا عضوياً في إدارة المجتمع والدولة ولم يتقوقع في الأمور الشخصية. منذ ١٤٠٠ عام تغيرت طبيعة المجتمع والدولة بشكل جذري عما كانت عليه في عصر الخلفاء الراشدين ولكن الفقه والتشريع الإسلامي حول علاقة الإسلام مع المجتمع والدولة والسلطة لم يوازي التغير العميق في المجتمعات والأنظمة السياسية
مبدئ “السياسة ليس لها دين والدين ليس فيه سياسة” هو مفهوم طوباوي غربي لا يمكن تطبيقه في مجتمعاتنا الإسلامية. وعلى الرغم من المظاهر الخارجية، فإن الغرب في الحقيقة لم يفصل أديانه عن سياساته بل استطاع يفصل رجال الدين عن السلطة وأن يصنع عقود اجتماعية وسياسية توضح وتضبط “علاقة” الدين بالسياسة. ولهذا عُقدة المسألة ليست في صياغة دستور يتم فيه فصل الدين عن السياسة أو ربطهما على الورق بل هي في دور الدين ضمن المجتمع وماهية “علاقة” الإسلام بالسياسة والسلطة الدنيوية. هل العلماء و “أهل الحل والعقد” هم من يمتلكون السلطة وهل سيطرتهم مطلقة وهل الدين والتدين ضرورة أساسية للعدالة القانونية والسياسية والاجتماعية وشرط أساسي للتقرب من مصادر السلطة؟
الكثير من “الإسلاميين” يرفضون الدولة المعاصرة بالكامل بغض النظر عن الأيديولوجية السياسية وينظرون للدولة المثالية من منطلق عقيدة “الولاء والبراء”. عندهم الأمة والدولة والخلافة لا تعني فقط “المسلمين” ولا تعني مجرد “المؤمنين” بل تعني فقط المؤمنين الذين يسيرون على الصراط المستقيم كما يراه أهل “الحل والعقد” ضمن الجماعة أو كما يراه أمير الجماعة؟ هذا الفكر يريد محاربة وقائع الحاضر بأوهام الماضي. هؤلاء لم ولن ينشئون دولة معاصرة ولن ينهضوا في أي مجتمع وليسوا موضوع هذه المقالة.
سوف يحاول البعض الأخر من “الإسلاميين” امتطاء الشعارات الإسلامية لأهداف دنيوية سلطوية بحتة وأن البعض سيحاول أن يبيع ويشتري ويُزايد بإسم الإسلام ليمتطي ظهر كرسي السلطة. والأمل أن شعوبنا لن تنسى أن استبداد البشر بإسم الله سيبقى إستبداد. يقول الكواكبي: “إنَّ الحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لم تكن تحت المراقبة الشَّديدة والاحتساب الّذي لا تسامح فيه”. لنتذكر أن الكواكبي كان يتكلم عن إستبداد عثماني بإسم الدين. إنه لا يمكن لهذه المراقبة أو الاحتساب أن تتم بغير توزيع السلطة إلى أطراف لا تتحارب وإضافة ميزان صندوق الانتخاب كمراقب ومحاسب للسياسيين مهما كانوا.
البعض الأخر ممن يحملون شعارات إسلامية يَرَوْن أن صندوق الانتخاب لا يتناقض مع الشريعة ويوافقون على التبادل السلمي للسلطة. التحدي هنا هو هل تتطابق الممارسة العملية مع هذه الشعارات؟ لا شك أن بعضهم يريدون حرق المراحل والوصول سريعاً إلى نتيجة معادلة مستحيلة تختصر “الشعب” ب “المسلمون” ثم تختصر المسلمون ب “المؤمنون”؟ وهكذا يتغاضى بعض ممن يرفعون الشعارات الإسلامية عن صندوق الانتخاب الذي يصنع “حكم الشعب” كمجرد خطوة مرحلية للتمكن من “حكم الله” أو “حكم الشريعة”. الواقع أنه لا يمكن لفريق واحد أو عالم شريعة واحد أو مرجعية دينية واحدة أن تكون لوحدها مرجعية “حكم الله” أو مصدر “قانون تشريعي ديني ودنيوي وحيد” يربط السماء بالأرض. هذا واقع معاصر في إمامة الفقيه الشيعية الفارسية نظراً لإن مصدر التشريع الشيعي موحد عند الإمام الفقيه ولكنه يتعارض جزرياً مع الإسلام الذي يتبع سُنة الله ورسوله) صلعم)
تبنى بعض الإسلاميين موقف رفض حكم الشعب من مُنطلق أن “الشعب” ربما يوافق على قوانين دنيوية تتناقض مع الشريعة الإسلامية وتصبح قانوناً للبلاد مُنافي للشريعة. نقطة الخلاف الأساسية هي: ماذا لو تناقض حكم أغلبية الشعب سواء كان (صندوق الانتخاب) أو مجلس شعب منتخب، ماذا لو تناقض مع حكم الله (البعض نص واضح في القرآن الكريم والسنة وليس فيه جدل والبعض موضع اجتهاد). الجواب يبدو بديهياً ويُختصر في أربعة نقاط
أولاً: إذا كان أغلب الشعب “مؤمن” فلا يمكن لهذا التناقض أن يحدث لأن الشعب لن يصوت بعكس إيمانه، أما إذا كان أغلب الشعب في “جاهلية” معاصرة فلنا في سيرة الرسول بالهجرة والدعوة بالحُسنى خير مقياس وأفضل طريق. هنا مجال عمل المؤسسات الدينية هو المجتمع وليس السلطة. إن استخدام سلطة الدولة لفرض الإيمان يتناقض مع نص القرآن الصريح “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي”.
وثانياً: هذا المفهوم يتناقض مع قوله صلّى الله عليه وسلّم “لا تجتمع أمتي على ضلاله”. فإذا ضّل “الشعب” فيتوجب تعليمه وإرشاده بالحكمة والنصيحة وحُسن التعامل بالمعروف. وهذا هو الطريق الأسلم والأفضل من فرض الإيمان بقوة سلطة الدولة. باختصار هذه التناقضات محتملة فقط إذا لم يكن أغلب الشعب “مؤمن” والحل هنا لا يكمُن بأن يتم فرض الإيمان على الأغلبية بقوة السلاح أو التهديد به (مثل المطوعين في السعودية) بل بالعمل الاجتماعي المنظم بالحُسنى والكلمة الطيبة. يقول الإمام محمد الغزالي رحمه الله “الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل … كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن … فالحرية هي أساس الفضيلة”.
ثالثاً: لا مفر من المساواة القانونية والحقوقية التامة بين كافة مكونات المجتمع بغض النظر عن التصنيفات الأثنية أو الدينية وهذا يتطلب ألا يُفهم حكم الأكثرية كأنه استبداد على الأقلية. لا يصح أن يكون الإيمان هو ميزان العدالة البشرية، الإيمان هو أحد مصادر العدالة السماوية، الإيمان هو علاقة خاصة بين المخلوق والخالق
رابعاً: هل يصُح أن تكون السلطة السياسية الدنيوية هي مصدر تشريع، تنفيذ وتطبيق الإيمان أم أنها مجرد أداة لخدمة الشعب من أفراد الشعب؟ هذه نقطة مهمة للغاية بحثها بالتفصيل العديد من المفكرين ومنهم فرانسيس فوكو ياما. يقول فوكو ياما (الذي بدء كتاباته بمفهوم أن العلمانية الغربية سوف تنتصر على باقي الحضارات ثم تراجع عن بعض مواقفه) أن المؤسسات الدينية الإسلامية السنية كانت على أغلب تاريخها “منفصلة” هيكليا عن السلطة على الرغم من أن كل أنواع السلطة، أكانت خلافة عثمانية أو عباسية أو غيرها كانت تستخدم المؤسسات الدينية وليس العكس. النقطة المهمة للغاية هنا أنه بسبب سيطرت أنظمة الحكم المتتابعة على المؤسسات الدينية الإسلامية، لم يتمكن التشريع الإسلامي السني من أن يُكوْن مفهوم موحد حول علاقة الدين والسلطة. فعلى الرغم أن مصادر التشريع الإسلامي الأربعة واضحة (القرآن الكريم، والسنة، والإجماع والقياس) فإنها جميعا لم توصلنا الى مفهوم موحد وواضح حول علاقة الدين بالسلطة، لهذا نجد السلفية التي تخضع للحاكم بشكل مطلق تتناقض كليا مع السلفية الجهادية ولا يزال مفهوم الشورى الملزمة يتناقض مع مفهوم شورى النصيحة
وبما أن تاريخ علاقة السلطة مع المؤسسات الإسلامية هو موضوع جوهري لهذه المقالة، فإن علينا الإجابة على تساؤلات مشروعة طرحها فرانسيس فوكو ياما في كتابه “أصول النظام السياسي” (عام ٢٠١١) حول علاقة الإسلام والسلطة
لماذا لم يستطيع علماء المسلمين منذ ألف وأربعمئة عام أن يفرضوا سلطة دينية توازن أو تضبط سلطة الخلفاء والملوك والسلاطين؟ بمعنى أخر، لماذا لم يستطيع علماء المسلمين في أغلب التاريخ الإسلامي صناعة سلطة دينية تضبط تسلط الملوك والخلفاء وانقسموا الى أما علماء سلاطين أو علماء معارضين لحكم السلاطين؟
لماذا لا يستطيع العلماء المسلمين السنة حتى الآن أن يتفقوا (بطريقة إجماع فقهي) على أدنى العوامل المشتركة لضوابط وأليات السلطة السياسية؟
باستثناء الخلفاء الراشدين، لماذا كانت السلطة العسكرية والسياسية منفصلة ومستقلة عن السلطة الدينية في أغلب تاريخ الإسلام السني؟
لماذا لم يستطيع علماء الإسلام السنة عبر تاريخهم أن يصنعوا مؤسسات دينية هرمية منظمة وقادرة على توحيد الصف والكلمة. علما أن العديد من الأديان التي لا تحتوي كهنوت بابوي ولا إماميه شيعية قد استطاعت أن تبني تنظيما مركزيا؟
لماذا لم تتطور القوانين المبنية على الشريعة الإسلامية في أحوال المجتمع والسياسة وضوابط السلطة وتقوقعت في الأحوال المدنية والشخصية؟
الأسئلة الخمسة لا تتعلق بالدِّين الحليف بقدر ما تتعلق “بتاريخ” علاقة الدين والسلطة في العالم الإسلامي. في الجدل المستمر والمعاصر حول العلمانية والإسلام لا يمكن لشعوبنا أن تنسلخ تماماً عن تاريخها بمجرد أن نزرع مفاهيم حديثة أكانت غربية أو شرقية لهذه العلاقة. ولكن أيضا لا يمكننا سوى أن نُحمِّل المؤسسات الدينية السنية جزء أساسي من مسؤولية الفشل التاريخي في الإجماع على فقه معاصر لا يتناقض مع الواقع ومستقل عن التاريخ.
عند مقارنة مبدأ مشروعية الشورى بمفهومها الإسلامي بالديمقراطية فإنك ستجد أن مفهوم “الشورى” ليس فقط مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بل أيضاً من تاريخ طويل من الخلفاء والسلاطين الذين سلبوا مفهوم الشورى من محتواه العملي. أما الديمقراطية فهي تستمد صلاحيتها ومشروعيتها من الشعب باعتباره مالك السلطة. هناك من يقول إن المفهوم الشرعي للشورى يتناقض كليا مع المفهوم المعاصر للديمقراطية
هنا أود أن أقول إن أسباب هذا التناقض والتحدي الأساسي ليس الجدل العقيم والنظري حول تناقض أو تناسب الشريعة الإسلامية مع المفهوم العلماني لسلطة الشعب، التحدي الأساسي هو كيف يتم اختيار من يملك السلطة وماهي ألية تبادل السلطة وكيفية خلق توازن يمنع فرد أو مجموعة أفراد أو حزب أو جماعة من التحكم في البلاد ورقاب العباد؟ رفض دور وأهمية صندوق الانتخاب ربما يحول مصدر السلطة إلى “الأقلية الفضيلة” التي تضع نفسها ليس فقط كمصدر السلطة السياسية بل كمصدر التشريع السماوي وبهذا يصبح “إن الحكم إلاّ لله” بيد فئة ترى سلطتها السياسية ذات مصدر إلهي ومن يختلف معها لم يعد معارضاً سياسياً بل كافر وخارج عن طاعة ولي الأمر والإمام. هناك في سورية أيضاً من يفرض بقوة السلاح “البيعة” لأمير مجهول يعيش في ظلام مدقع أو في أحد فروع المخابرات الدولية؟
ضاع القرن الماضي في جدل بيزنطيني حول دور الشريعة الإسلامية في “دستورات” العديد من دول الاستبداد في الشرق الأوسط. ومنها الخلاف حول “ال” التعريف كالقول أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع” أم أنها “المصدر الرئيسي للتشريع”. ولكن أهم ما ضاع هو حقيقة أن طبيعة “السلطة” الاستبدادية لم ولن تتغير مهما كان نص الدستور. حتى يتم توضيح تناسب مفهوم الشورى مع الديموقراطية، هناك أسئلة لم يتوصل علماء المسلمين السنة (علماء السلطة و علماء المعارضة) حتى الآن الى إجماع فقهي حول الإجابة الواضحة عليها وهي:
كيف يتم اختيار “أمير” الجماعة أو “الخليفة” أو “الرئيس” ومن يقوم بتزكيته ومن يحق له أن “يبايع” أو يصوت له؟
هل يصبح الأمير (أو الرئيس) أميراً مدى الحياة أم لفترة محددة؟ إن التاريخ الإسلامي الحافل بعلماء الدين الذين وهبوا السلاطين حقاً سماوياً بأن يحكموا حتى الممات ثم يورثوا الحكم لأبنائهم بشتى الطرق هو من صميم مشكلة الاستبداد المستعصية في بلادنا
هل يصبح بيد “الأمير” كل القرارات ويُصبح ذا سلطة مطلقة أم أنه يبقى ذو سلطة محدودة؟
من يملك الصلاحية أن يُسائل الحاكم على أفعاله دون أن “يكسر عصى الطاعة”؟
بعض الاتجاهات السياسية الإسلامية تُصر أن مفهوم “الشورى” لا يتضمن إلزام ولي الأمر بالشورى وأن الشورى هي للنصيحة فقط وليست مُلزمة. وبعضهم لا يرى ضرورة للشورى من عامة الشعب بل من فئة قليلة مُختارة (أهل الحل والعقد)؟ من هم أهل الحل والعقد ومن يختارهم وكيف يتم اختيارهم؟
أحد أهم التحديات الأساسية للإسلام السياسي هو أن يتفق جمهر العلماء والمفكرين الإسلاميين على مفهوم إسلامي معاصر وواقعي حول مصدر السلطة وأليات ضبطها. لقد مضى مائة عام على زوال الخلافة العثمانية ولكن لم ينتهي إرث الخلاف حول كيفية اختيار وشروط بقاء وطُرق تبديل “أمير المؤمنين” عند بعض الإسلاميين أو رئيس الجمهورية عند البعض الأخر. وهكذا يستمر الجدال العقيم حول شكل الدولة الإسلامية الفاضلة بين آمال إعادة صنع نظام الخلفاء الراشدين وواقع عالم إسلامي مُشتت ومتناقض.
تحدي شعوب المنطقة لن يكون الخلاف حول الأيديولوجية السياسية ولن يكون حول نص أي دستور بل سيكون حول مقدار كفائه وأخلاق وإخلاص من يصعد إلى دفة الحكم. وبما أن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة فإنه لا مفر من عدة مكونات أساسية
ضرورة توزيع “السلطة” أفقياً وعامودياً بشكل ألا يتحكم بها شخص واحد أو مجموعة واحدة مهما كانت
ضرورة الاحتفاظ بأدوات قوية للمراقبة والاحتساب كمجلس للشعب وقضاء مستقل
التوصل لعقد اجتماعي عميق يتفهم أن مصدر السلطة الأساسي هو صندوق الانتخاب
حرية الرأي وحرية الإعلام هما أيضاً ضامنان أساسيان للمراقبة والاحتساب
تفاهم اجتماعي عميق وضمانات عملية بأنه لا يحق لمن يملك الأغلبية السياسية أن يسلب الأقلية أية من حقوقها
إن ما حدث في الجزائر ثم مصر قد دمر الثقة في صندوق الانتخاب عند شريحة أساسية من المجتمع العربي. نأمل أن تنجح التجربة التونسية والتركية في إعادة بناء هذه الثقة. شعار الإخوان المسلمين التاريخي هو أن “الإسلام هو الحل” بينما شعار العديد من العلمانيين هو أن “الإسلام هو المشكلة“. لن تنهض بلادنا حتى يتفق أغلب علماء المسلمين حول مفهوم مصدر السلطة وأليات تبادلها وضوابط التحكم بها؟ للأسف علماء المسلمين لا يزالون أكثر تفرقاً من مجتمعاتنا الممزقة؟ يجب أن يُوضح أغلبية العلماء علاقة الإسلام المعاصر بالسلطة والسياسة. وهكذا نأمل أن يتمكن علماء المسلمين المعاصرين والمثقفين الأكاديميين والنخبة الاجتماعية والاقتصادية من صناعة “حل للمشكلة” عن طريق فقه معاصر يُزيل كاهل تاريخ الاستبداد وعن طريق عقليات متنورة تتقبل الاختلاف بل وتثمنه
ملاحظة: لم أكتب هذه المقالة من منطلق علم الشريعة لأنني لست متمرس وخبير بها ولموضوع الشريعة علماء وخبراء أفضل مني، ولم أكتب هذه المقالة من منطلق فكري بحثي نظري أكاديمي يعود لخبراء المجتمع والسياسة بل رغبت في طرح هذا الموضوع من منطلق عملي ومن وقائع خبرة عملية عشتها في مناصب حكومية في ولاية كاليفورنيا خلال ١٨ عام بما فيها ٤ سنوات في منصب رئيس بلدية ثاني أكبر مدينة في محافظة سان دييغو. أما حان الوقت لأوطاننا أن تتجاوز صراع الطواحين حول نظريات سياسية لا تتطابق مع واقع العصر وتقدم البشرية
فإن أصبتُ فلا عجب ولا غرر
وإن نقصتُ فإن الناس ما كملوا
والكامل الله في ذات وفي صفة
وناقص الذات لن يكمل له عملُ